تحل، اليوم، الذكرى الـ 36 لوفاة صاحب رائعة "الربوة المنسية"، الكاتب والمفكر والأنثروبولوجي مولود معمري "1917-1989"، تحاول "الخبر" من خلال هذه اللفتة استذكار أمجاد صاحب عدة روائع أدبية وروائية، منها "الأفيون والعصا"، "الربوة المنسية"، "عفوة العادل" و"العبور" والتي اقتبست بعضها في أفلام كبيرة نالت الشهرة عالميا، لنفتح النقاش اليوم، رفقة كتّاب وروائيين على مواقف معمري الذي عانى من ويلات المستعمر في صغره، ولم ينس معاناة عائلته وأبناء قريته من الذل والبطش الفرنسي، ليجعل من الفرنسية التي تعلّمها وأتقنها، أداة لضرب العدو وكشف أكاذيبه للعلن.
قالت الدكتورة آمنة بلعلى، جامعة مولود معمري تيزي وزو، إن ذكرى الروائي والأنثروبولوجي واللساني، مولود معمري، تحل لتذكّرنا، ليس فقط بإعادة الاعتبار لبعض الرموز الوطنية المقاومة التي ظلت هضبات منسية فحسب، ولكن لكي نتعلّم منها كيف نطوّر آليات التفكير التي تجعل من طروحات أصحابها أفكارا منتجة نستطيع أن نواجه بها إكراهات الهيمنة المقنعة التي تتغذّى من رواسب الكولونيالية. ونتعرف عن منجزاتهم وأنساقهم الفكرية التي اشتغلوا فيها من داخل اهتماماتهم بالثقافة الوطنية.
ماذا لو عاد مولود معمري بيننا اليوم؟
وذكرت الأستاذة آمنة بلعلى في تصريح لـ"الخبر"، أنه لا يمكن فهم النسق المعرفي الذي اشتغل من خلاله مولود معمري، إلا من خلال فهم تصوّره للثقافة الشعبية الوطنية التي آمن بها منذ أن كتب "الهضبة المنسية"، التي صوّر فيها المجتمع الجزائري في منطقة القبائل، وهو يعيش أصناف الذل والهوان في ظل استعمار غاشم ونال بها جائزة فرنسية رفض تسلّمها آنذاك، فكان مساره منذ البداية مسار مناضل ضد الكولونيالية. وحسب بلعلى، فقد جسّدت روايات طبيعة الثقافة الشعبية التي تعاش داخل المجتمع وتمارس فيه، لأنها تنتج داخله وتقاوم الإكراهات الخارجية، فكان مفهومه للثقافة المعيشية استراتيجية نضالية ضد الزوال ونكران الهوية ومظاهر الاستلاب ونسيان الوجود.
يذكر مولود معمري، تقول الأستاذة، تراجع دور الأئمّة والعلماء بسبب المؤسسة الاستعمارية، في حين بقيت الثّقافة الشفوية والشعر خاصة، على الرغم من تقلص شروطه الموضوعية، بل وجدناه يتّخذ روحا جديدة، من خلال عبقرية شعرائه الذين عبّروا عن نمط جديد من الوجود الإنساني في الجزائر "مثلما تجلى في شعر سي محند أومحند، باكتشافه الكوجيتو الذي يقوم عليه (سفْرو نك أذْ هَدْرَغ)، وحين يتكلم الإنسان يثبت أنه إنسان وأنه حي، أي أنه موجود". وأكدت بأنه ومن هنا لا يمكن النظر إلى مولود معمري إلا باعتباره عقلا مركّبا محرّضا على الاختلاف داخل الوحدة، موجّها نحو التحرر، محافظا على اللغة والثّقافة، ساعيا إلى آفاق الحداثة الرحبة، مؤسسا لثقافة المقاومة ومتموقعا في المنطقة الحرجة للمثقف الملتزم والمناضل في الواقع، ممارسة فعلية وإبداعية، ولذلك ظلّ هاجسه الأساس هو التمكين للثقافة التي يحيا بها الجزائريون كفعل للمقاومة وللوجود الحر.
أكدت بلعلى أن معمري كان من أهم المثقفين الجزائريين الذين ارتبط وعيهم، وفي سنّ مبكرة، بموضوع الثقافة الوطنية، بحثا وإبداعا حتى بات يعدّ من أهمّ مفكّري الثقافة الجزائرية إلى جانب مالك ابن نبي اللذان شكّلا، حسبها، ملامح العقل الثقافي الجزائري، بل أسّسا لدراسات ما بعد الكولونيالية وبلغة المستعمر "على الرغم من خصوصية التوجّه الذي جعل مالك ابن نبي يجنح إلى بناء المفاهيم، في حين كان توجّه مولود معمري ردّا عمليا أنثروبولوجيا لسانيا وكذلك إبداعيا. وأوضحت الدكتورة أن هذا الوعي هو الذي قاد مولود معمري في رحلته الأنثروبولوجية والاهتمام بالثقافة الشعبية، لأنه كان يريد أن ينبّهنا إلى قوة الجذب هذه التي تحملها هذه الثقافة باعتبارها نسقا يحرّر من الاستبداد والعنصرية، وهو ما يعطيها طابعا عقلانيا ويقود إلى عالم الأخوة والوحدة في الاختلاف التي ناضل من أجلها حتى وفاته.
وختمت بلعلى "لقد تساءل مولود معمري في مقال له سنة 1963 "لو عاد ابن خلدون بيننا" وأنهى المقال بقوله: "لو عاد سيكون مرتاحا بهذا الجو الأخوي الذي تنبّأت به عبقريته"، فماذا لو عاد مولود معمري بيننا اليوم؟ هل كان سيشعر بالغبطة لأن عبقريته التي جعلته يتساءل سنة 1980 لماذا لا توجد قناة تلفزيونية ناطقة بالأمازيغية؟ ولماذا لا تدرّس الأمازيغية في المدارس، هل سيشعر بالغبطة لأن أسئلته تحققت وأصبحت الأمازيغية لغة وطنية ورسمية؟".
معمري أدرك مبكرا بأن الاستعمار هو البلاء الأعظم الذي لحق بالجزائريين
قال الأستاذ محمد داود، من جامعة وهران، إن الأديب والباحث في علم الأنثروبولوجيا، مولود معمري، ينتمي إلى جيل الخمسينيات من الأدباء الجزائريين، من أمثال محمد ديب وكاتب ياسين ومولود فرعون الذين قاموا بقطيعة نهائية مع الفكر الكولونيالي وأدبه. وقال في تصريح لـ "الخبر"، إن الاستعمار الفرنسي كان يعتقد أن مهمته آنذاك في الجزائر هي مهمة حضارية، أي القيام بإخراج "الأهالي" من التخلف وإدماجهم في الحضارة والتطور، ولكن الأمر لم يكن كذلك، فقد جاء الفرنسيون إلى الجزائر لاحتلال البلاد واستعباد أهلها والسطو على خيراتها، من أراض خصبة ومواد أولية ومعادن نفيسة. وقام الاستعمار، حسبه، فيما قام به، بعد أن استولى على الأرض، بـ"احتلال العقول"، من خلال نشر ثقافته ولغته بواسطة التعليم. وذكر محمد داود، أن مولود معمري الفقير منذ صغره، قد أدرك أن الاستعمار هو البلاء الأعظم الذي لحق بالجزائريين، إذ كان يذهب إلى المدرسة التي بنتها الإدارة الفرنسية في قريته سنة 1883، "حافي الرجلين في الثلج"، لكنه تعلّم هذه اللغة وأبدع فيها، كما استغلّها لفضح الكوارث والمصائب التي تسببت فيها هذه الظاهرة الاستعمارية.
وأوضح داود أن الرسالة التي كتبها إلى صديقه "جون سيناك" المناهض للاستعمار، في 30 نوفمبر 1956، أي في خضم الحرب التحريرية، تكشف عن عمق موقفه من الاستعمار، إذ يقول له: "في النظام الاستعماري، لا يمكن أن يكون هناك قديس ولا بطل ولا حتى موهبة متواضعة، لأن الاستعمار لا يحرر، بل يقيّد، ولا يربي، إنه يظلم ولا يعزّ، بل يجعلك تيأس وتميل إلى الجمود، إنه لا يجلب المحبة والتآلف، بل يسعى إلى التقسيم والعزل ويدفع بكل إنسان إلى عزلة يائسة".
وضمن هذا السياق الاستعماري القاسي والصعب على الجزائريين، يقول محمد داود "كتب معمري ونشر العديد من النصوص الأدبية، منها "الربوة المنسية" سنة 1952 التي كانت بمثابة صرخة في وجه الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها منطقة القبائل في بداية الحرب العالمية الثانية التي أرغم الاحتلال شباب المنطقة ومناطق أخرى من الجزائر للمشاركة فيها، وكان مولود معمري أحدهم. والرواية تذكر، حسبه، أيضا الصراع بين الشباب والشيوخ حول الكثير من القضايا الاجتماعية التي ترتبط بالعادات والتقاليد التي تعيق أي تطور أو تغيير اجتماعي "كان ذلك في أجواء قاهرة، حيث انتشار الجوع والأمراض نتيجة الشتاء مع قساوة البرد التي تميزه. وتشير الرواية وبشكل خفي إلى المقاومين الذين حملوا السلاح آنذاك ضد الاحتلال".
معمري فكك الخطاب الاستعماري وأكاذيبه حول "المهمة الحضارية"
قال وليد بوشاقور، أستاذ مساعد في الدراسات الفرانكوفونية، كلية ترينيتي، جامعة ييل الأمريكية، إنه إذا أردنا الحديث عن مولود معمري ومناهضة الاستعمار، يمكننا أن نبدأ بروايته "الأفيون والعصا" التي يشكل الفيلم المقتبس عنها والذي أخرجه أحمد راشدي جزءًا من مخيلتنا الجماعية.
وذكر الأستاذ بوشاقور في تصريح لـ"الخبر"، أن معمري تعاون أيضا مع راشدي في فيلم "فجر المعذّبين"، وهو عمل مركزي آخر في بناء السردية الوطنية. وصرح "بصفته روائيا وباحثا وكاتبا مسرحيا ومثقفا عاما، أن عمل معمري حول الثقافة الأمازيغية هو في الأساس عمل للتحرر من الاستعمار بمختلف أشكاله". وفي مواجهة منتقديه، أكد معمري دائما، حسب المتحدث، على البعد الوطني والمغاربي للثقافة الأمازيغية. وقال "صحيح إن القوى الاستعمارية الفرنسية حاولت تقسيم الجزائريين من خلال خلق "الأسطورة القبائلية"، لكن الأعمال الحديثة لمؤرخين مثل ياسين تملالي، تظهر أن هذه الاستراتيجية فشلت في إقناع سكان أو مثقفي المنطقة الذين حاربوا الاستعمار بقوة".
أوضح بأن معمري بدأ مشواره بإظهار تناقضات الوضع الاستعماري الذي تفاقم في فترة الحرب العالمية الثانية في رواياته الأولى، مثل "الربوة المنسية" و"غفوة العادل"، من خلال سرد حياة مجتمع محلي شبيه بقريته الأصلية "تاوريرت ميمون". يمكن رسم خط يربط أعماله المبكرة ومسرحيته" La mort absurde des aztèques" التي تثير مسألة التحرر على نطاق دولي، مرورا بنصوصه ومداخلاته المناهضة للاستعمار والتي نجد فيها نفس التعلق بتحرير الأرض والوطن. "وكما تعلمون، فإن كلمة (تامورت) في اللغة القبائلية تعني الأرض والبلاد في آن واحد. بالنسبة لمعمري، ترتبط الأبعاد المحلية والوطنية والعالمية ارتباطا وثيقا. على سبيل المثال، إذا قرأتم أعمال معمري حول الشعر القبائلي، سترون أنه يربط هذا الشعر بالملحون وبالثقافة الشعبية الجزائرية بجميع لغاتها".
وأضاف "ومن الأمثلة على التزام معمري المناهض للاستعمار، التقرير الذي كتبه عام 1957 لصالح جبهة التحرير الوطني، بهدف رفع القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة". وحسبه، فقد أظهر فيه فهما عميقا للقضايا الدولية التي تنطوي عليها مكافحة الاستعمار، ربما كانت هناك خلافات داخلية حول الطريقة التي يجب اتباعها، لكن معمري كتب بشكل لا لبس فيه، أن المهم هو استقلال الجزائر. وعلى حد تعبيره، فقد كتب أن مبدأ الدولة الجزائرية المتحررة من أي ارتباط أو تقاسم للسيادة أمر لا جدال فيه". فبالإضافة إلى تجذّره في الثقافة الشعبية القبائلية، تمتع معمري حسب الأستاذ بوشاقور بميزة الإطلاع الجيد على الثقافة الفرنسية والغربية. وقد مكّنه ذلك من تفكيك الخطاب الاستعماري وعلى وجه الخصوص الأكاذيب حول ما يسمى بـ"المهمة الحضارية" للاستعمار. في مقالاته في ذلك الوقت، حلّل معمري النظام الاستعماري باعتباره مشروعا لتجريد الإنسان من إنسانيته، "آلة سحق"، تماشيا مع فكر مؤلفين آخرين مناهضين للاستعمار مثل فرانتز فانون وإيمي سيزير.
كتابات وأعمال معمري في السينما
من جهته، تحدّث الناقد السينمائي محمد عبيدو، عن المفكر والأنثروبولوجي، مولود معمري، وأعماله الروائية التي جسدت في السينما. وقال إن معمري أثرى الساحة الأدبية والثقافية عبر ما يزيد عن السبعة عقود. ويعتبر صاحب العديد من الروايات، منها "الأفيون والعصا" التي تم اقتباسها للسينما من قبل المخرج أحمد راشدي و"الربوة المنسية" التي اقتبست أيضا للسينما، وكتب بالأمازيغية "نوم العادل"، إضافة إلى مسرحيات وقصائد شعرية وقصص.
تحدّث عبيدو عن إنجاز فيلم وثائقي حول حياة وأعمال مولود معمري الأدبية والفنية للمخرج علي موزاويو. وقال إنه وردت في فقرات الفيلم الناطق باللغة الفرنسية والتي دامت 52 دقيقة، مقتطفات من المقابلات الصحفية التي أجراها الكاتب مولود معمري حول أعماله، إلى جانب شهادات حية أدلى بها كل من الكاتبين الراحلين طاهر جاووت ورشيد ميموني بشأن رواياته ودواوينه الشعرية والقصصية القبائلية العريقة التي أنقذها من خطر الشفوية والضياع ببذله في شأنها جهدا علميا في جمعها وتدوينها وتمحيصها. كما أظهر الفيلم، يقول عبيدو، جهود معمري في دفاعه المستميت على الأمازيغية كمكوّن أساسي لهوية الشعب الجزائري، إلى جانب العروبة والإسلام، من خلال روايته "الربوة المنسية" وتنديده بمظالم الاستعمار الفرنسي في عمله الرائع "الأفيون والعصا" التي حوّلت إلى فيلم ناجح وطنيا ودوليا، إلى جانب إسهامه في إبراز أهمية تراث "أهليل" الموسيقى التقليدية لمنطقة قورارة بالولاية المنتدبة تميمون الذي أسرعت منظمة اليونيسكو بعد انبهارها به بتصنيفه كتراث عالمي. كما عاد عبيدو إلى ما قام به المخرج عبد الرحمن بوقرموح عام 1998 بتحقيق فيلمه "الربوة المنسية" عن رواية "الربوة المنسية"، وهي أول رواية لمعمري نشرها عام 1952 والتي تبتدئ وقائعها في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، لتصوّر الوضع في الجزائر تحت ظل الاحتلال الفرنسي "إنها تعبّر عن فترة اليأس والقنوط من دون أية إمكانية العثور على حل لأن الاستعمار لا يقدم الحلول في نظره أيا كان الأمر، فإن بوادر الأمل بدأت تلوح في أعقاب الحرب العالمية الثانية كنتيجة للتغيّرات التي طرأت على الوضع السياسي في الجزائر".

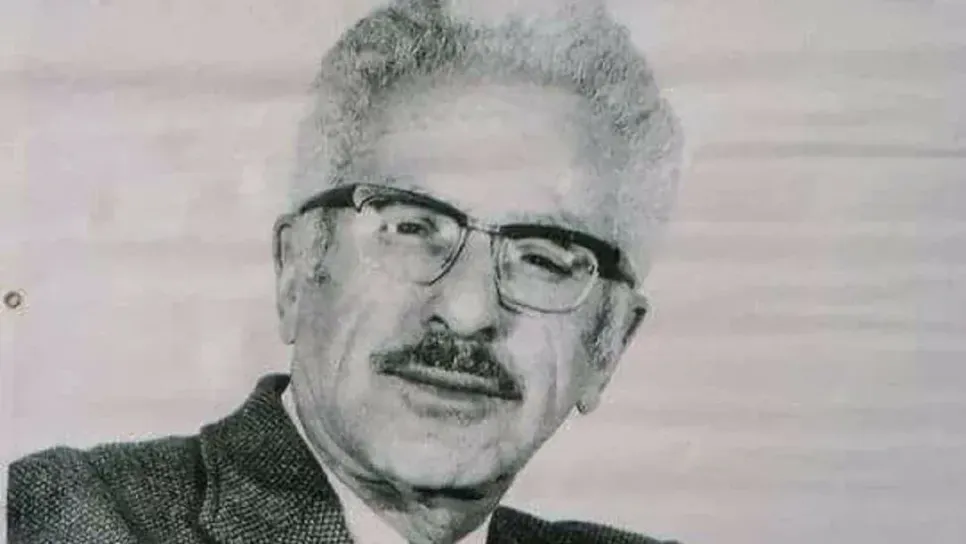






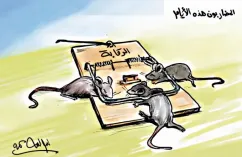
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال